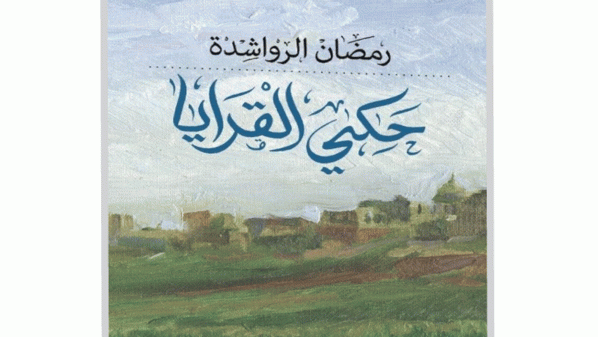الدكتور أنس الزيود
من هنا يمكن القول إنَّ الرواية سجل للحياة لمجتمع ما في عصر معين، والروائيّ مؤرّخ بشكل من الأشكال، لكنَّ عمله التأريخيّ يتّخذ طابعاً غير الطابع الذي يسير عليه عمل المؤرّخ، إنَّه طابع القالب الفنّيّ والسرد الأدبيّ، فتؤدّي الرواية بذلك وظيفتين: وظيفة جماليّة تربّي ذائقة القرّاء وتنمّي فيهم ميولاً إيجابيّة عبر ما تُثيره فيهم من إحساس بالمتعة والدهشة، ووظيفة توثيقيّة تضع أمام القارئ صورة لواقع الحياة الذي تصوّره الرواية لمجتمعٍ ما في حقبة زمنيّة معيّنة، فيتعرّف القارئ عبر الرواية على نظام القيم والأخلاق في ذلك المجتمع، وعادات أفراده وتقاليدهم وأنماط عيشهم وطرق تفكيرهم، فلا يمكن فهم مجتمع ما من دون الاطلاع على آدابه وفنونه، وقديماً كان الشعر هو ديوان العرب، وسجل وقائعهم ومآثرهم، لكن في العصر الحديث أصبح هذا الدور – رصد الحياة وتسجيلها – منوطاً بالرواية أكثر من باقي الأنواع الأدبيّة.
هذه العلاقة المبنيّة على التفاعل والتبادل بين الفنّ الروائيّ والتاريخ، لقيت قبولاً واستحساناً من الأدباء، واهتماماً ودراسة من النقّاد، وشيئاً فشيئاً تطوّر هذا التفاعل وأدّى لظهور ما يعرف بالرواية التاريخيّة، ومن أوائل من أشار إلى هذا المصطلح حرفيّاً (والتر سكوت) في مطلع القرن التاسع عشر.
وبفعل الاتصال الثقافيّ وحركة الترجمة استفاد الأدباء العرب من تجربة الكُتّاب الغربيين في توظيف التاريخ في الأعمال الروائيّة، فظهرت أعمال تمزج بين التاريخ والرواية مثل قصّة (زنوبيا) لسليم البستاني التي أصدرها سنة 1871، وسلسلة روايات تاريخ الإسلام لجرجي زيدان (1891 – 1914)، و(أورشليم الجديدة) لفرح أنطون 1904، و(أمير لبنان) ليعقوب صرّوف 1907، وظهرت لاحقاً مجموعة من الأعمال الروائيّة التاريخيّة حازت شهرة واسعة في الوطن العربي، يحتاج الحديث عنها لوقفة مطوّلة.
لكنَّ مزج التاريخ بالسرد الروائيّ ليس بالأمر السهل، فربما يطغى التاريخ، فتصبح الأعمال ضعيفة من حيث البناء الفنّيّ، وفقيرة بالدراما اللازمة لتحقيق التشويق والإثارة، وربما يطغى الخيال فيغدو العمل الروائيّ مسخاً وتحريفاً فاضحاً للتاريخ. عملية التأليف – إذن – تحتاج لقراءة مُلمّة ومستفيضة للحقبة التاريخية، ولخيال خصّب خلّاق يعرف كيف يوائم بين الشخصيات المتخيّلة والتاريخيّة، ويعرف كيف يخلق الأحداث التي تتشعّب وتتداخل مشكّلة بناء الرواية، مع الحفاظ على الحدث التاريخيّ الذي سجّلته المصادر، دون أن تحاول محوه أو تحريفه، بل إنَّ الكاتب يدفع القارئ لإعادة النظر فيه من جديد أثناء قراءة الرواية وبعدها، وهذا يجعل العمل الروائيّ جسراً يربط الماضي بالواقع الراهن.
هذه المواءمة بين المتخيّل والتاريخي نجح فيها الكاتب رمضان الرواشدة في عمله الموسوم بِـ»حكي القرايا»، تحقّقت هذه المواءمة من تجلّي الواقعيّة في هذا العمل الفنيّ الرصين، فبالرغم من محدوديّته نسبياً، إذ يمكن تصنيفه رواية قصيرة (نوفيلا)، لا يتعدّى مئة صفحة، لكنّه مكثّف بالأحداث، وغنيّ بالدلالات والاستنتاجات التي يخرج بها القارئ بعد إكمال قراءته.
إنَّ الواقعية كانت أهمّ عناصر النجاح الفنيّ في عمل الرواشدة، ومعروف أنَّ المذهب الواقعي يهتمّ بتصوير الحياة ومظاهرها بعيداً عن المثاليّة، فيغدو العمل الأدبي مرآة تعكس حياة الأفراد في المجتمع بصدق ودقة؛ لأنَّه يُصوّر الحياة بتناقضاتها، بقبحها وجمالها، وخيرها وشرّها، وبساطتها وتعقيدها، وبهذا يكون العمل الروائيّ صورة مصغّرة عن الحياة.
والرواشدة في عمله (حكي القرايا) تطرّق لواقع الحياة الذي كان يعيشه الناس في الجنوب الأردنيّ في الحقبة التي تعرف بالرجل المريض من تاريخ الحكم العثمانيّ، وهي فترة عصيبة عانت فيها الخلافة العثمانية من صراعات إقليميّة مع القوى الأوروبيّة على المستوى الخارجيّ، وحركات تمرّد وعصيان مسلّح من بعض الولايات التابعة لها على المستوى الداخليّ، وهذه الأحداث عامة انعكست على واقع الحياة الذي كان يعيشه السكان في المناطق الخاضعة لسلطة الخلافة.
هذا الانعكاس وتأثيره وتداعياته رصده الرواشدة في جنوب الأردن، عبر قصة مطوّلة تعدّدت الأحداث والشخصيات فيها، وتداخلت وتشابكت، امتزج فيها التاريخيّ بالمتخيّل، مُبرزاً بساطة الحياة وقسوتها، وصراعات القبائل وتحالفاتها، وشهامة الأفراد وخِسّتهم، وكفاح الناس لتأمين عيشهم من مخاطر الغزو وقطّاع الطريق، وحرصهم على شرفهم وكرامتهم، حتى لو فقدوا الحياة من أجل ذلك، كلّ ذلك كشف عنه الرواشدة في عمله، لذا يمكن نعته بالواقعيّة التاريخيّة.
توزّعت الرواية على اثني عشر فصلاً، جاءت متسلسلة بشكل أفقيّ زمنيّاً، لكنّ النمو الدراميّ للأحداث أخذ منحىً تصاعديّاً عموديّاً، فكلّ حدث يمثّل جزءاً قائماً بذاته، ينمو وتتصاعد مع نموه مُخيّلة القارئ، بدءاً بزواج منصور الأعمى، وحلف القرايا للتصدّي لغزوات المناعسة، وملاحقة الجيش المصريّ للثائر الفلسطينيّ (قاسم الأحمد) قائد ثورة الفلاحين في نابس والخليل، وحصار القلعة، وكيف تمكّن منصور الأعمى بحكمته وحنكته من التصدي للجيش المصريّ والحفاظ على القلعة وحياة أهلها.
هذه الأحداث وغيرها تشابكت في ما بينها مكوّنة بناء الرواية، والقارئ في تتبّعها لا بـدّ أن تستوقفه مظاهر الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي أزاحت الرواية الستار عنها، فالمنطقة تكاد تكون منسيّة وغائبة عن حسابات الباب العالي واهتمامات الوالي في بلاد الشام، الفقر والجهل يبسطان ظلالهما على أبناء المنطقة، لدرجة أنَّ «أغلب أبناء القرية يصومون نصف نهار، ولا يصلّون الصلاة المعروفة، إذ لم يكن في القرية خطيب شاميّ يعلّمهم أصول الصلاة والصوم، ولم يكن ثمّة جامع للصلاة، وكثيراً ما كانوا يعلمون بشهر رمضان بعد انتهائه»، ولك أن تتخيّل أنَّ أهل القرية يصلهم نبأ قدوم شهر رمضان من فارس يقدم إليهم، فإذا لم يصلهم الفارس أو لم يُعلمهم، أمضوا عامهم بلا رمضان ولا عيد.
هذا إلى جانب مواجهة قُطّاع الطرق المُنفلتين عن قبائلهم، أمثال جماعة (الدعجان)، وبعض الجماعات التي تجوب البلاد قادمة من مناطق العراق وشمال الجزيرة العربية، هذه الجماعات المُنفلتة أودت بحياة الكثير من أبناء القلعة التي تقع على إحدى هضاب سلسلة جبال الشراة، وكانت غاراتهم هاجساً يقضّ مضاجع أبناء القلعة، فلم يكن بـدّ من إقامة حلف لمواجهتهم، إنّه «حلف القرايا».
وبالرغم من حياة الفقر والجهل التي كان يعيشها ذلك المجتمع البدويّ، وانعدام الأمن أحياناً، كان للمرأة مكانة وحظوة عندهم، ظهر ذلك في شخصية (فاطمة السالم) زوجة منصور الأعمى، التي كان كثيراً ما يأخذ بمشورتها في المواقف المهمة في حياته، فقد أخذ برأيها عندما اقترحت عليه أن يُسمّي المنطقة الجديدة التي سيسكن فيها بـ(الجاية)؛ «لأنَّ الجايات ستكون أحسن من الرايحات».
ولا تقتصر المظاهر الإيجابيّة على احترام المرأة وتوقيرها، فقد بيّنت الرواية بعض العادات الحميدة التي كانت منتشرة عند أبناء المجتمع البدويّ في الجنوب الأردنيّ، مثل (الدخالة)؛ إغاثة المستجير والدفاع عنه، فقد التجأ الثائر الفلسطينيّ قاسم الأحمد إلى عشائر الكركية يطلب الحماية، بعد أن أخمد المصريون بقيادة إبراهيم باشا ثورة الفلاحين، وكان الشيخ إبراهيم الضمور مع زوجته علياء قد آويا الدخيل الفلسطينيّ وأكرماه، ورفضا تسليمه للجيش، فتعرّضت قلعة الكرك لحصار وقصف عنيف من الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا، الذي أرسل من يساوم الشيخ إبراهيم الضمور، لكنَّ الأخير رفض تسليم الدخيل، فهدّده الضابط المصريّ بحرق ولديه (علي والسيد) أمامه وأمام زوجته والكركيّة، ومع ذلك لم ينثنِ الشيخ عن موقفه هو وزوجته علياء، التي قالت قولتها المشهورة: «المنية ولا الدنية».
وإلى جانب الدخالة، كشفت الرواية عن عادة الفزعة؛ تقديم العون والنجدة لمن يطلبهما، وكشفت أيضاً عن الحميّة وعدم القبول بالضيم، ورفض الرجوع عن الثأر، فحتى عادة الثأر فيها تكريم وتعظيم للميت المغدور، بالرغم ممّا ينتج عنها من إراقة للدماء، وقد بيّنت الرواية أنَّ أبناء عشائر جنوب الأردن كانوا يلبسون «شماغاتهم» مقلوبة عكسيّاً فوق رؤوسهم، كناية عن طلب الثأر.
وإلى جانب العادات الحميدة، أظهرت الرواية العادات والتقاليد التي كانت سائدة في مناسبات الأعراس والأفراح، كالسامر والدحية والمهاهاة والزغاريد التي كانت تُطلقها حناجر النساء تعبيراً عن فرحهن، بالإضافة إلى الأهازيج والقصيد الذي كان يردّده الأفراد، وقد أوردت الرواية عدداً لا بأس به منها.
هذا عن الواقع الاجتماعيّ الذي كشفت عنه الرواية، أمّا بخصوص التاريخيّ، فقد تطرقت الرواية لحملة إبراهيم باشا، الوالي المصري الذي كان يهدف إلى إخضاع الجنوب الأردنيّ لسلطته؛ من أجل تجنيد الفلاحين في الجيش المصريّ، وفرض الضرائب والمكوس عليهم من أجل تمويل حملته، وتداعيات هذه الحملة على بلاد الشام، فقد أدّت لحركات تمرّد وعصيان رفضاً لواقع الظلم والتسلّط المفروض على السكان.
واستمرّت سياسة الأتراك العثمانيين في الجباية من أموال الناس ومحاصيلهم، وأخذ الرجال عنوة للمشاركة في الحروب، فأدّى ذلك إلى توالي حركات العصيان ضد التعسّف التركي، وأبرزها ما حدث في ثورة الكرك التي أُطلق عليه اسم «الهيّة»، وكانت هذه الأحداث كلّها إرهاصاً لإعلان ثورة العرب ضد الحكم التركيّ لنيل استقلالهم، وقد شارك معظم أبناء الجنوب الأردنيّ في هذه الثورة.
وإضافة إلى هذه الأحداث التاريخيّة المفصليّة، لفتت الرواية النظر لبعض الأحداث المغيّبة من المصادر التاريخيّة، مثل حادثة (صباح الدعجان)، التي كانت قبائل جنوب الأردن تؤرِّخ لها؛ لأنَّها تمثّل علامة فارقة في مسيرة الصراع بين العشائر وبين الجماعات التي تنهب وتسلب وتقطع الطرق.
وأيضاً المكان الذي قُتل فيه منصور الأعمى، أطلقت عليه القبائل اسم «مقتل منصور»، وما زال الاسم معمولاً به إلى يومنا هذا في دائرة الأراضي والمساحة، فلم تُغيّر الدولة الأردنية بعد تأسيسها – في عشرينيّات القرن العشرين – هذا الاسم.
هذه الأحداث التاريخيّة والمتخيّلة وما امتزج بها من مظاهر اجتماعيّة وعادات وتقاليد صوّرتها الرواية، نجح الكاتب رمضان الرواشدة في صهرها معاً في قالب روائيّ مُحكَم، ضمن سرد فنيّ سلس ملتئم في عباراته وتراكيبه، خلا من الحشو الزائد والحوار المصنوع، والتعابير المتكلفة، لكنّه لم يخلُ من ألفاظ اللهجة الأردنيّة الدارجة، وبعض أمثالها الشعبيّة المتداولة، وهذا أضفى مسحة واقعيّة على رواية تتناول حقبة تاريخية مُغيَّبة من المصادر المكتوبة، لكنّها محفوظة في المتناقل الشفويّ عبر الأجيال، فحريٌّ إذن أن توصف بالواقعيّة التاريخيّة، وأن توسم بِـ»حكي القرايا».