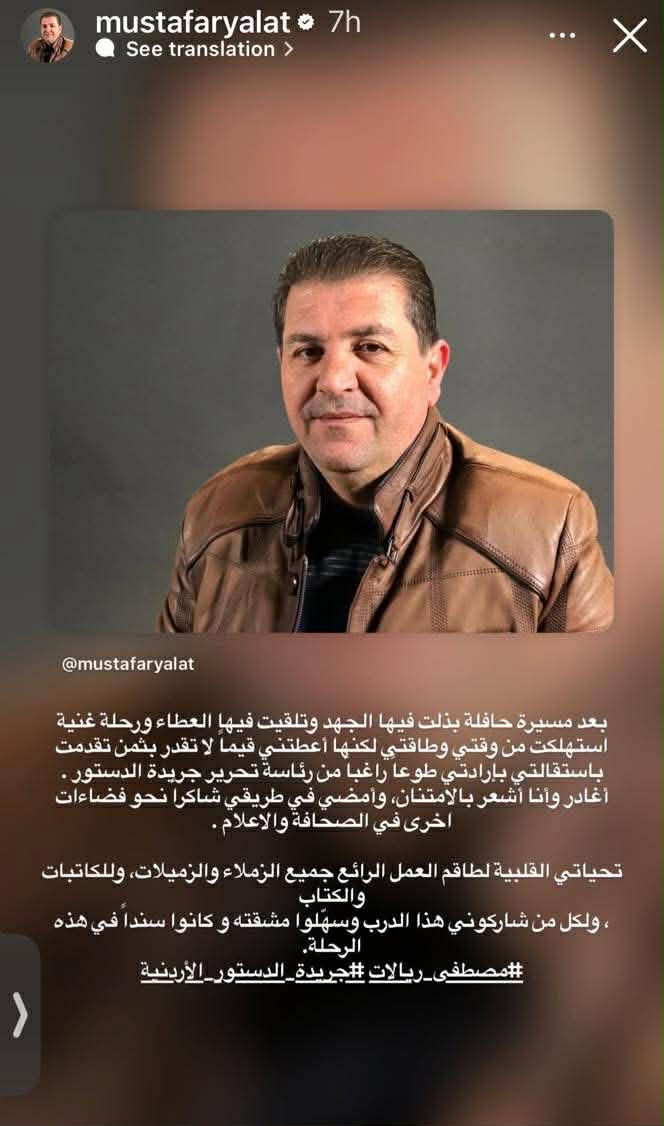عبدالله بني عيسى يكتب
لا يكاد التاريخ العربي يخلو من ثورات وانتفاضات واحتجاجات، من ثورة الزنج، مرورًا بـ “الفتنة الكبرى” وما تلاها، وصولًا إلى الثورة العربية الكبرى ثم ثورات الربيع العربي. ومع ذلك، فإن القاسم المشترك بينها هو التعثر أو الفشل في التحول إلى مشروع نهضوي مستدام. السؤال الذي يفرض نفسه هنا: لماذا تتكرر التجربة ذاتها بالنتيجة ذاتها؟
الجواب الأقرب أن الثورة بلا مشروع سياسي وثقافي ومعرفي متراكم لا تدوم. الفعل الثوري مهما بدا صادقاً أو صاخباً، يبقى لحظة عاطفية إن لم يحمله مشروع ثقافي–مؤسسي متماسك، يترجم الغضب إلى نظام وقانون ومعرفة، ويجعل من الشارع في ظروف معينة بداية لمسار لا مجرد انفجار عابر.
في الفكر السياسي، يلحّ غرامشي على أن «الهيمنة الثقافية» تسبق «الهيمنة السياسية». والواقع يثبت أن الثورات التي تفتقر إلى حاضنة ثقافية معرفية متراكمة تنهار سريعاً أو تتحول إلى فوضى. الثورة الفرنسية لم تكن لتنجح لولا أن التنوير سبقها بعقود. والثورة الأمريكية حملت معها فلسفة جون لوك وتوماس باين. وحتى الثورة البلشفية، وإن بدت عمالية الطابع، إلا أنها قامت على تنظير ماركسي–لينيني صلب.
في المقابل، تبدو الصورة العربية مختلفة. فثورات كبرى مثل ثورة الزنج حملت دوافع اجتماعية واقتصادية قوية، لكنها انطفأت سريعاً لأنها لم تنجح في تأسيس مشروع ثقافي جامع. أما الثورة العربية الكبرى، فعلى الرغم من رمزيتها العالية، فقد انتهت إلى تجزئة سياسية بفعل الاستعمار وصراعات الشرعية، ولم تحقق هدفها الأسمى في الوحدة (الاستثناء الأردني هنا يعكس القدرة على تحويل الطاقة الثورية إلى بنية شرعية ومؤسسية مستدامة، وهذا هو بيت القصيد الذي تفتقده معظم التجارب العربية) . أما الربيع العربي، فقد جسّد النموذج الأوضح لفعل ثوري عاطفي افتقر إلى مشروع ثقافي أو مؤسساتي قادر على البناء، فانتهى إما بارتداد الأنظمة القديمة، أو بالفوضى والعسكرة والانقسامات. وإذا ما اعتبرنا 7 أكتوبر فعلاً ثورياً على الظلم والقهر والاحتلال، فإنه بالمآلات نفسها الذي انتهى إليه يقدم دليلاً على فشل الفعل الثوري مع غياب المشروع.
الحراك الذي تشهده مدن المغرب منذ أواخر أيلول/سبتمبر 2025 مثالٌ حي. فقد انطلقت احتجاجات «جيل زد» بمطالب ربما تكون مشروعة في الصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية، وامتدت عبر تنسيق رقمي لامركزي (منصات مثل ديسكورد وتيك توك)، لكن سرعان ما تحولت إلى موجة وطنية واسعة، شهدت صدامات دامية وسقوط ضحايا، مع دعوات متصاعدة لإقالة الحكومة.
هؤلاء الشباب لا يُلامون، فمطالبهم عادلة وأصواتهم طبيعية في مجتمعٍ يفتش عن أفق، لكنهم مقطوعي الصلة بماضي مجتمعهم وخبرتهم تكاد تكون معدومة. المشكلة في نخب ثقافية وفّرت الغطاء والشعارات من دون مشروع متماسك قابل للبقاء. فالمثقف العربي «الثوري دائمًا» يكرر الخطأ ذاته: يرفع السقف مع الشارع، لكنه لا يقدم إطارًا ثقافيًا أو مؤسساتيًا يُترجم هذه الطاقة إلى مسار إصلاحي طويل الأمد.
وهنا ينبغي التذكير بوضوح: الحل لن يكون بسيطًا؛ فتوفير غطاء ثقافي للفعل الثوري لا يتم في يوم وليلة، بل هو حصيلة تراكمية لعقود طويلة من التجربة والإنجاز. الأثر الحقيقي للمثقفين لا يُقاس في المدى القريب، وإنما بما يراكمون من أطر معرفية قابلة للديمومة، تضع الأخلاق والعلم والمنطق في صدارة الأولويات. ولو أُتيح لبعض الأنظمة العربية أن تُصلح نفسها من داخل المؤسسات القائمة على كل ما فيها من علل وعطب، ربما كان الوضع اليوم أفضل في مصر واليمن وتونس وليبيا وحتى سوريا والعراق. من هنا فإن الغطاء الثقافي الذي يقدمه بعض مثقفينا الثوريين “على عجل” ينطوي على خطأ لا يُغتفر، لأنه يكرر دورة الفشل ولا يكسرها.
الشعوب العربية، للأسف، تجتر الفشل وتعيد إنتاج مقاربات ثبت عجزها. كل جيل يكاد يكرر تجربة سابقة، من دون أن يتوقف طويلًا عند دروس الماضي. أما النخب الثقافية، فهي مسؤولة عن هذا الدوران في الحلقة نفسها، حين تكتفي بالشعارات ولا تؤسس لمشروع ثقافي–مؤسسي حقيقي.
الدرس الذي لا مفر منه أن التغيير يبدأ من حيث بدأ الناجحون: من مشروع ثقافي معرفي يرسخ القيم الجامعة، إلى تصميم مؤسسي يضمن العدالة وسيادة القانون، إلى تنظيم سياسي قادر على تحويل مطالب الشارع إلى سياسات، ثم يأتي الشارع نفسه كأداة ضغط شرعية ومنضبطة. أما عكس ذلك؛ شارع قبل ثقافة، وغضب بلا مشروع، فهو مجرد إعادة تدوير للماضي، ونسخة جديدة من الفشل.