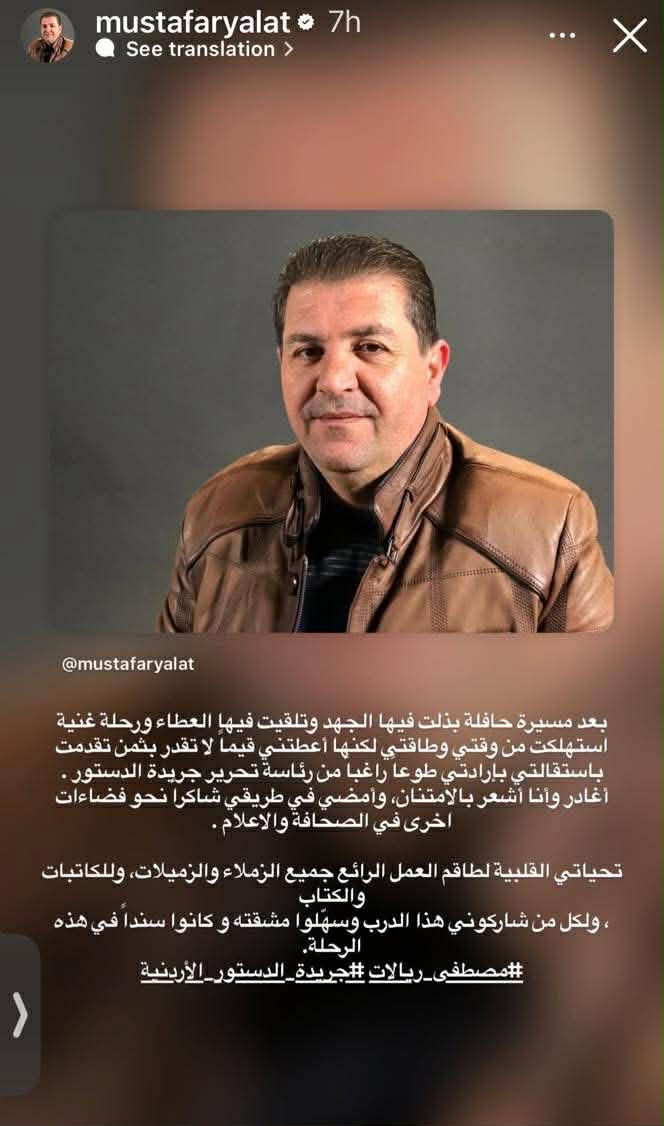دكتورة ناديا محمد نصير – أخصائية العلاج النفسي
في مساءٍ مشحون بالصمت والذهول، استقبل قسم الطوارئ في أحد المستشفيات الأردنية فتاة في الثامنة عشرة من عمرها، بالكاد تتنفس، وملامحها منهكة، وجسدها يئن من الكدمات. لم تأتِ من حادث مروري، ولا من سقوط عرضي. بل من بيتٍ قرر أهله، بمحبة مغلّفة بالخوف والجهل، أن يسلموها إلى رجل غريب، مدّعي “الرقية الشرعية”، ليُخرج من جسدها “جنّيًا” ظنّوا أنه السبب وراء تأخّر زواجها حتى هذا السنّ. لم يسأل أحد إن كانت تشكو من ألم، أو من حزن، أو حتى من ضغط اجتماعي خفي جعلها تنكمش على ذاتها. كل ما فكروا فيه، أن الحل لا بد أن يكون خارقًا، لا منطقيًا، عنيفًا، لا إنسانيًا، وأن الوجع النفسي يمكن ضربه ليخرج… كأن النفس كيس طحين يُصفَع حتى ينفض عن ذاته ما علق به. لكن النفس ليست كذلك. النفس ليست كتلة لحم تُضرب فتشفى، وليست صندوقًا مظلمًا يختبئ فيه “جنّ” مسؤول عن كل ما نجهله ونخافه. النفس كيانٌ معقّد، دقيق، هشّ أحيانًا، وصلبٌ أحيانًا أخرى، لكنها دومًا، دومًا، تحتاج إلى الفهم، لا العنف. حين ننظر إلى فتاة في عمر المراهقة، ونُفسّر قلقها، أو صمتها، أو انطوائها، على أنه مسّ شيطاني، فإننا لا نُخطئ بحقها فحسب، بل نُخطئ بحق كل معنى للإنسانية. لأننا نغتال فرصتها في أن تكون مفهومة، محتضنة، نمنحها صك إدانة لمجرد أنها لم “تتصرف كما نحب”، ولم “تتزوج في الوقت الذي نراه مناسبًا”. في علم النفس، هناك مصطلح يُعرف بالانفصال (Dissociation)، يحدث حين تتعرض النفس لضغط لا يمكن تحمله، فتلجأ إلى الانفصال عن الوعي الكامل، كآلية دفاع داخلية. هذا الانفصال قد يُترجم بنوبات فقدان مؤقت للسيطرة، أو حركات لا إرادية، أو حتى أصوات غريبة. وفي المجتمعات الواعية، يتم تفسير هذا على أنه عرض نفسي قابل للعلاج. أما في مجتمعات أخرى، حيث يتفوق الخوف على الفهم، فيُفسّر فورًا على أنه “تلبّس جنّي”، ويُعامل على هذا الأساس، فيُضرب الجسد ليُخرَج ما ليس فيه. نحن لا نخاف من “الجنّ” بقدر ما نخاف من مواجهة أنفسنا. من الاعتراف أن ابنتنا ربما تعاني من قلق مزمن، أو اضطراب ما بعد الصدمة، أو اكتئاب دفين، أو ربما من ضغوط عائلية تجبرها على الظهور بمظهر “الصالحة”، حتى وهي تنهار من الداخل. حين تعجز الأسر عن فهم ما تمر به بناتهم، يُسارعون إلى إلقاء اللوم على “السحر”، لأن السحر لا يُحاسَب عليه أحد، ولا يقتضي منّا مجهودًا في الإصغاء، أو التغيير، أو الاعتراف بالتقصير. تُظهر الدراسات النفسية الحديثة أن أكثر من 65% من الفتيات في الفئة العمرية ما بين 15 و21 عامًا يُعانين من أعراض قلق واكتئاب بدرجات متفاوتة، وأن كثيرًا منهنّ لا يلجأن إلى العلاج النفسي، ليس لأنهن لا يحتجن إليه، بل لأن المجتمع يُلبس المعاناة النفسية عباءة العار، أو يُحوّلها إلى أسطورة غيبية. بل إن بعض الأمهات، عن حسن نية أحيانًا، وبدافع من القلق والتأثر بالموروث الشعبي، يلجأن إلى “شيخ” أو “معالج”، يُمارس سلطة نفسية خطيرة على الفتاة، تبدأ بالإيحاء وتنتهي بالضرب. وهكذا، يتحول الجرح النفسي الأول إلى صدمة مضاعفة: الأولى في النفس، والثانية في الجسد. في كثير من الحالات التي تعاملنا معها سريريًا، كانت بداية الانهيار النفسي الحقيقي للفتاة بعد جلسة عنيفة مماثلة. كانت الضربات التي تلقتها على جسدها هي الضربات الأخيرة على ثقتها بنفسها. وكأنها تتعلم أن جسدها ليس ملكها، وأن مشاعرها لا تعني شيئًا، وأن صوتها لا يُسمع، مهما صرخت. هذا النوع من العنف النفسي المقنّع يُخلف ندوبًا لا تُرى، لكنه يُشوّه العمق الإنساني في داخل الضحية، ويتركها مشوشة، خائفة من نفسها، غير قادرة على تصديق أنها طبيعية، أو تستحق الحب. ما جرى لتلك الفتاة ليس مجرد حادثة، بل مرآة لمجتمع يرفض مواجهة ألمه، ويختبئ خلف الأساطير ليبرّر فشله في احتضان أفراده. مجتمع يرى في البنت التي لا تضحك كثيرًا أنها مصابة بسحر، لا بأنها حزينة؛ يرى في التي لا تريد الزواج مبكرًا أنها ممسوسة، لا أنها تملك رأيًا؛ يرى في التي تعاني من اضطرابات النوم أو الشهية أو التفكير، أنها “تحتاج شيخًا”، لا جلسة علاج سلوكي معرفي. هذا الإنكار الجماعي للمشاكل النفسية ليس ضعفًا في الوعي فقط، بل تواطؤ غير معلن على قمع الإنسان داخل كل فرد، خصوصًا النساء. الفتاة التي نُقلت إلى المستشفى ليلًا لم تكن تبحث عن الجنّي، بل كانت تبحث عن ذاتها. ربما كانت تحاول أن تقول شيئًا بلغة جسدها، أو في صمتها، أو في نوبات ضيقها، لكن أحدًا لم يُصغِ لها، بل سلّمها إلى من أسكت جسدها بالضرب، وأقنع الجميع أن “الشفاء قد بدأ”، بينما الحقيقة أن النزيف بدأ، لكن ليس فقط من الكبد أو الطحال، بل من كرامة فتاة تجرأت على أن تكون مختلفة. ما نحتاجه ليس فقط قانونًا يُجرّم هذه الممارسات، بل حركة مجتمعية تُعيد تعريف “المرض النفسي” كجزء من الصحة، لا كوصمة. نحتاج أن نعلّم في المدارس كيف نُصغي، وكيف نفرّق بين حالة روحانية وصدمة نفسية، وكيف نرعى أولادنا بعقلٍ لا يرتجف كلما تغيّر مزاجهم، أو خفتت طاقتهم، أو اختلطت مشاعرهم. نحتاج إلى مجتمع لا يخاف من الاكتئاب، بل يعرف كيف يُعالجه. إلى أمهات وآباء لا يلجأون إلى الشيخ فورًا، بل إلى حضنٍ دافئ، وسؤال بسيط: “كيف تشعرين؟” نحن لا نحتاج إلى مزيد من الضرب، بل إلى مزيد من الفهم. لا نحتاج إلى إخراج “الجنّ”، بل إلى إدخال الوعي. لا نحتاج إلى ترديد الرقى، بل إلى قول الحقيقة: أن الفتاة التي تُعاني، يجب أن تُسمع، لا أن تُجلد. وأن الخوف من المجتمع لا يجب أن يدفع بنا إلى إيذاء من نحب، باسم حمايتهم. في النهاية، كل ضربة تلقتها تلك الفتاة كانت صرخة مبحوحة تقول: “أنا موجوعة، لا ممسوسة.” وكل كدمة على صدرها كانت محاولة دفاع عن ذاتها، عن حريتها، عن عقلها، عن كيانها الذي أرادوا إعادة تشكيله بما يناسب أساطيرهم، لا حقيقتها. فهل سنستمر في تكرار المشهد ذاته؟ أم آن الأوان لنقول، بصوتٍ عالٍ، أن الضرب ليس علاجًا، وأن الجهل ليس إيمانًا، وأن الفتاة ليست ملكًا لأحد… إلا لذاتها؟