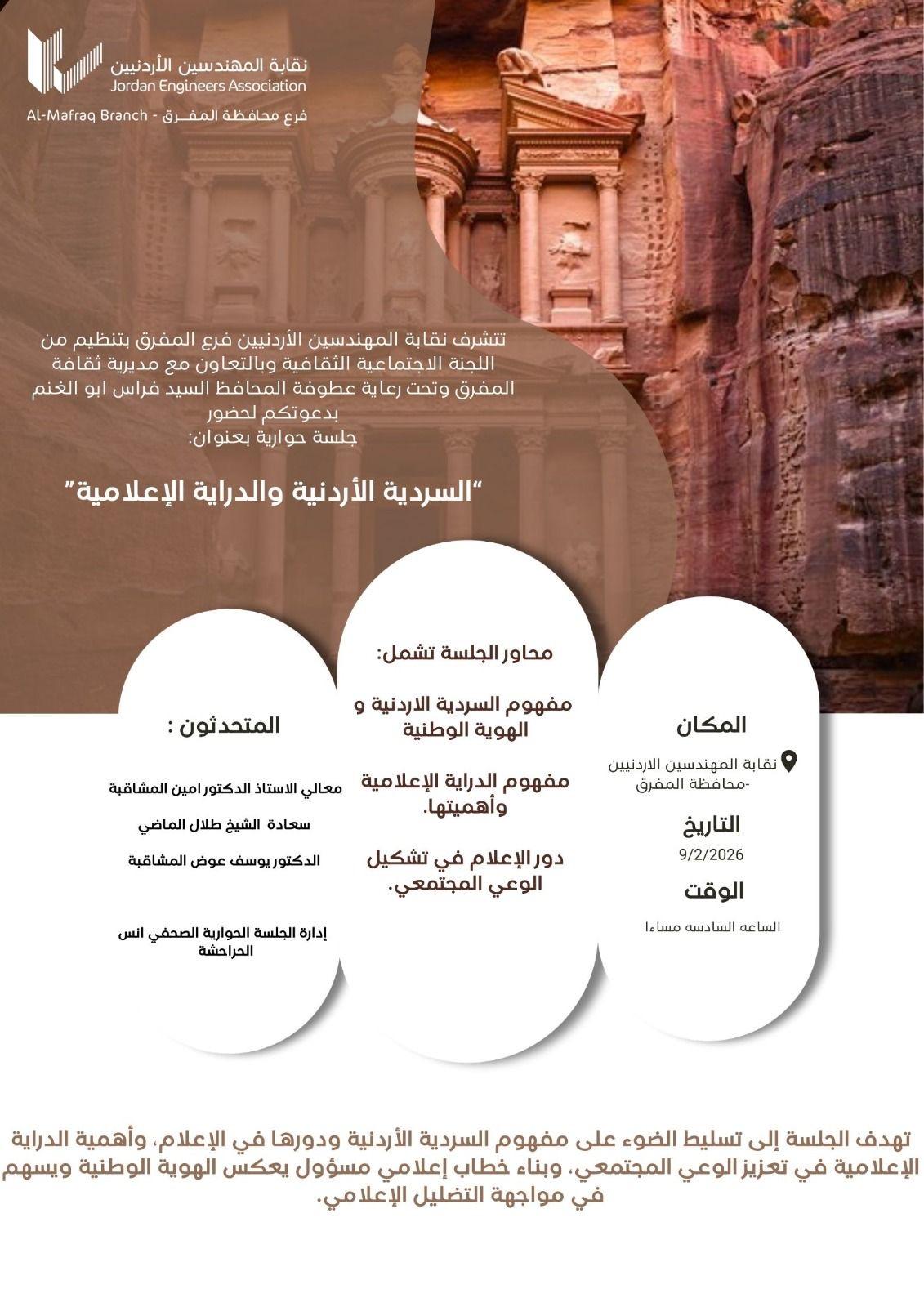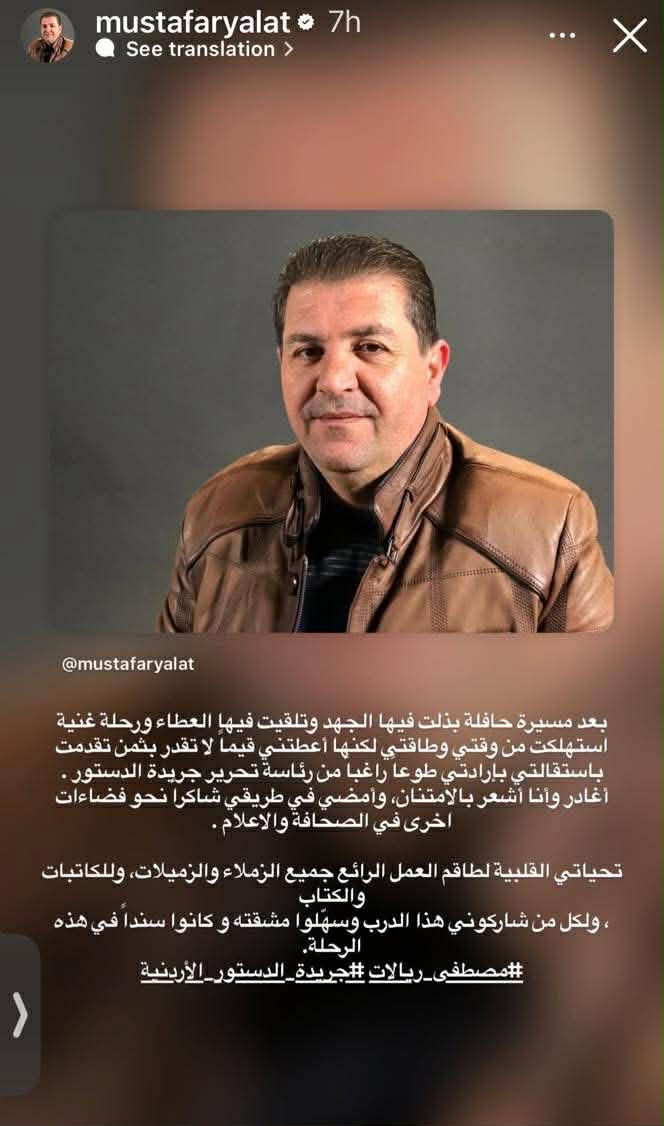إنجاز-ثُعَذْ المرحلةُ الابتدائيّةُ أساسًا محوريًّا في البناءِ المعرفيّ والنفسيّ للطفلِ، إذ تتشكِّلُ خلالها البُنى الأولى للفهمِ والسلوكِ والتفاعلِ الاجتماعيّ. وفي هذه المرحلةِ المفصليّة، يبرز دور المعلّمين والمعلّماتِ بوصفهم العمودَ الفقريّ للعملية التربويَّةِ، الأمرُ الذي جعلَ من دراسةٍ تأثيرِ جنسوم واتجاهاتِهم التربويَّةِ محورًا لعددٍ من الأبحاث في الأدبياتِ التربويَّةِ الحديثةِ، لا سيّما في ضوءٍ تزايد الاهتمامِ بالممارساتِ الصفيَّةِ التي تفضي إلى نتائج تعليميةٍ فعّالةِ.
نشيرُ تقاريرُ تربويَّةٌ صادرةٌ عن منظماتٍ دوليَّةِ مثل اليونسكو (2018) ومؤسساتٍ تقييم تربويّ إقليميّةِ، إلى وجود فروقٍ ملحوظة بين الذكورِ والإناثِ من المعلّمين في طرائق التدريس وأسلوب إدارةِ الصفّ، حيثُ تميلُ المعلّماتُ إلى اعتماد أنماط تعليمية تشاركيَّةٍ قائمةٍ على الدعمِ العاطفيّ والاحتواءِ الانفعاليّ للطلبةِ، ما يعزّز من استجابتهم ويُنمّي مهاراتهم غير المعرفيّة، وهو ما تؤكِّده دراساتٌ نوعيّةٌ أَجريت في كندا .(Hargreaves & Fullan, 2012) وأستراليا
في المقابل، تُشيرُ دراساتٌ أَخرى نُشرتْ في مجلَّة
Teachingand Teacher Education واح
المعلِّمين الذكورَ يُفضِّلون الأساليب التوجيميَّةَ القائمة على الانضباط، ويُبدون تركيزًا أعلى على الأداء الأكاديميّ المجرد، كما يوظّفون أدواتٍ التنافس لتحفيزِ الطلبةِ، لا سيَّما في البيئاتِ الصفِّيَّةِ ذاتِ التحدياتِ السلوكيَّةِ.
فيما يتعلَّقُ بالتحصيلِ الأكاديميّ، تفيد مراجعةً شاملةً لمركزِ البحوثِ التربويَّةِ التابع لجامعةٍ كامبريدج (2017) بعدم وجود فروقٍ ثابتة في أداء الطلبة تعزى مباشرةً إلى جنس المعلّم، بل تعودُ بدرجةٍ أكبر إلى كفاءةِ المعلّمِ وأساليبه.
ومع ذلك، لوحظ أنْ المعلماتِ يُبدين فاعليَّةً أكبر في تعزيز مهارات القراءةِ والكتابةِ في الصفوف الأولى، خاصَةً لدى الطالباتِ، بينما سُجِّل تحسرّ نسبيّ في أداء الطلبة الذكورِ في الرياضياتِ والعلومِ عند تدرسِهم من قِبلِ معلِّمين ذكورٍ، وهو ما تفسّره نظرجةُ النمذجةِ السلوكيَّةِ
.(Bandura, 1986)
أما على مستوى السلوكِ والانضباط الصفيّ فتشيرَ دراساتٌ ميدانيَّةٌ أجريت في مدارس بريطانيّةٍ ومغربيَّةٍ إلى أنّ وجودَ معلّمينَ ذكورٍ قد يكون مرتبطا بانضباطٍ أعلى لدى الطلبةِ الذكورِ في بعضِ السياقاتِ، خاصَةً تلك التي ثُعاني من تفككٍ أسريّ أو ضغوط اجتماعيَّةِ. في المقابل، أظهرتِ المعلماتُ قدرةً واضحةً على خلقٍ بيئةٍ صفيَّةٍ داعمةٍ، تُحفِّرُ التفاعلَ والمشاركةَ وتُقلِّلْ من سلوكياتِ العزلةِ والانغلاق.
يمتذ هذا التأثير أيضًا إلى المجالِ العاطفيّ والاجتماعيّ، حيث تؤكّدٌ مراجعاتٌ منوجيّةً أُجريت
National Institute for) في الولايات المتحدة
ngạg gÎ (Early Education Research, 2020
المعلّماتِ في السنواتِ الأولى يُعراً من النمو الاجتماعيّ للطفل، ويُسمم في بناء ثقته بنفسه وتطورٍ مهاراتِه التفاعليّةِ. كما يُعَد التنوعُ الجندريُ في الميئةِ التعليميَّةِ عنصرًا بنَّاءَ يُعطي للطلبةِ نماذج متعدّدةً من التصرّفِ والتفكير.
أمّا على مستوى النظامِ التربويّ العامّ، فقد أظهرتْ تقارير صادرة عن منظمة التعاون والتنميةِ الاقتصاديَّةِ (OECD) أنّ تنويع الميئةِ التعليميَّةِ بين الذكورِ والإناثِ يُسهمُ في تعزيز العدالةِ التربويَّةِ، وكسرِ الصورِ النمطيّةِ، وتنميةِ المهاراتِ الحياتيّةِ للطلبةِ. وهو ما يجعل من السياساتِ التربويّةِ التي تدعمُ المساواة الجندرية في التوظيف خيارًا استراتيجيًّا لبناء أنظمةٍ تعليميةٍ أكثر شمولًا ومرونةً.
وبناءً على ما سبق، يُستخلّص أنّ الاتجاهاتِ التربويَّة والممارساتِ التدريسيَّة تبقى العاملَ الأشد تأثيرًا في نتائج التعثمِ، بينما يُعد جنش المعلّمِ عاملًا مكمّلًا في سياقاتٍ محدودةِ. ومن هذا المنطلقِ، تبرزُ الحاجةُ إلى تبتّي سياساتٍ تربويَّةٍ تعزّزُ التنويع الجندريّ في التوظيف للمرحلةِ الابتدائيّةِ، وتُوفِّرُ برامج تدريبٍ مهنيّ تراعي الفروق الفرديَّةَ والجندريَّة، وتُشجِّعُ على إنتاج أبحاثٍ محليّةِ تُضيء على هذه التفاعلاتِ في السياقاتِ الثقافيَّةِ المتنوّعةِ، مع ضرورةِ ترسيخ وعي? تربويّ ناقد لدى المعلَّمين والمعلّماتِ تجاة ممارساتِهم داخل الصفّ.